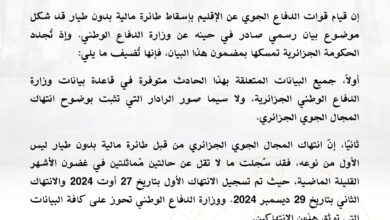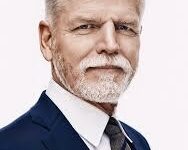صيدنايا: هندسة الشر بين تفاهة الإجرام والامتثال الطائفي


حين نجحت فصائل الثورة السورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 باقتحام سجن صيدنايا، المعروف بسمعته المروعة والذي يوصف أيضًا بـ”المسلخ البشري”، انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة من داخل السجن. هذه الصور أعادت للأذهان ما أطلقت عليه الفيلسوفة الألمانية اليهودية حنة آرنت مصطلح “تفاهة الشر” (The Banality of Evil).
الهندسة والسلطة في سجون الأسد
لو تسنّى للفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو دراسة تصميم سجون النظام السوري، وخاصة سجن صيدنايا، وما شهده من ممارسات وحشية، لوجد أن أفكاره حول السجون وتصميم “البانوبتيكون” (Panopticon) الذي اقترحه جيرمي بينثام بحاجة إلى مراجعة. فقد صُمّم سجن صيدنايا عام 1987 ليحتجز آلاف السجناء السياسيين والمدنيين، ويقع شمالي دمشق على بعد 30 كيلومترًا. يتميز تصميمه بثلاثة مبانٍ مترابطة تتقاطع في نقطة مركزية تُعرف بـ”المسدس”، وتحتوي على الطوابق الأرضية والزنازين الانفرادية التي تُعدّ الأكثر تحصينًا.
يرى فوكو أن الهندسة ليست مجرد علم رياضي، بل أداة تُوظّف لخدمة مفاهيم الانضباط. وقد أشار إلى أن الدول الحديثة تبني مؤسساتها بأسلوب “بانوبتيكي” يمكّن السلطة من مراقبة الأفراد بشكل دائم. إلا أن ممارسات النظام السوري تجاوزت هذا المفهوم، ليصبح “الصيدناتكي” نموذجًا للسيطرة المطلقة التي تخوّل السجّان ليس فقط المراقبة بل أيضًا التعذيب والقتل بلا قيود.
تفاهة الشر أم امتثال اجتماعي وطائفي؟
تُعيد مشاهد صيدنايا طرح تساؤلات حول دوافع مرتكبي الجرائم. هل هم مجرد منفذين للأوامر أم تحرّكهم دوافع أيديولوجية وطائفية؟ في دراسة نشرها الباحث الحاج محمد الناسك بعنوان “صيدنايا المسلخ البشري: تفاهة الشر أم امتثال اجتماعي؟”، أشار إلى أن جلادي صيدنايا يختلفون عن الجنود الألمان الذين وصفهم المؤرخ كريستوفر براونينغ في كتابه “كتيبة الشرطة الاحتياطية 101”، حيث نفّذ الجنود الألمان الجرائم تحت ضغط الامتثال الاجتماعي رغم نفورهم منها.
بينما يرى براونينغ أن الغالبية امتثلت خوفًا من الرفض المجتمعي أو فقدان السلطة، قدّم دانييل جوناه غولدهاغن تفسيرًا مغايرًا في كتابه “جلادو هتلر الراغبون في التنفيذ”. فقد اعتبر أن دوافع الجنود لم تكن فقط امتثالًا اجتماعيًا، بل نتاجًا لثقافة سياسية معادية للسامية متجذرة بعمق.
استثنائية جرائم صيدنايا
مع أن مقاربة “تفاهة الشر” التي صاغتها آرنت تناسب وصف جرائم النازيين، فإنها قد لا تفي بفهم جرائم صيدنايا، حيث لعبت النزعة الطائفية دورًا رئيسيًا في تكوين سلوك الجناة. لم يمتلك السجّانون في سجون الأسد خيار الرفض الذي أتيح لجنود كتيبة 101، بل تحرّكوا بدوافع أيديولوجية قائمة على الامتثال الطائفي.
لفهم جرائم نظام الأسد التي امتدت لأكثر من نصف قرن، لا بد من دراسات معمّقة تعتمد على شهادات السجّانين والضحايا والوثائق. كما يُبرز اختلاف استنتاجات براونينغ وغولدهاغن أهمية تحليل الأدلة بعناية وطرح أسئلة دقيقة لفهم هذه الجرائم الاستثنائية.