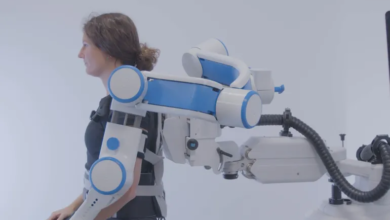تطلع علينا ، من حين لآخر، أقلام و ألسنة” تدافع” عن الإسلام تحت عنوان إبراز فضل الإسلام على العرب. هذا الفضل عظيم عظمة بلا حدود و لا يجادل فيها إلا مكابر و جاحد لأعظم نعمة من رب الناس على الناس كافة ؛ خاصة العرب منهم. و الإسلام بالنسبة للعرب بمثابة النور بالنسبة لمادة المصباح. فلا المصباح مشع بذاته و لا النور مضيء من دون تكثيف في المصباح. و كما أن مادة المصباح متميزة في خصائصها فكذلك العرب متميزون في خصائصهم. و مع أن الله قادر على أن يشع النور من أي جسم معتم بطبيعته ، إلا أنه ، في مشيئته، قدر أنه لا يمكن للنور أن ينبثق من مادة الخشب … كذلك أراد الله ، بحكمته و مشيئته، أن يجعل الإسلام، الذي هو نور و ضياء و هدى ، منبثق من رجل من العرب ؛ فكانوا مادة التكثيف التي يصدر عنها نور الإسلام في كل اتجاه من زوايا الأرض. لقد سبق العرب جميع الأمم في مقاومة رسالة الإسلام و رفضه، كما سبق العرب جميع الأمم و الشعوب في حمل رسالة الإسلام و نشرها في فجاج العالم و الدفاع عنها بأعلى و أغلى أنواع التضحيات بالأموال و الأنفس و الفكر و الوقت… فلم تتفرغ أمة لنشر رسالة مثلما تفرغ العرب من أجل الإسلام… و لم تتحمل أمة من التضحيات و المعاناة في سبيل ما تؤمن به مثلما تحمّله العرب من أجل رسالة الله الخالدة- الإسلام و قيمه العادلة!
فلما ذا اختص الله العرب بأن بعث فيهم و منهم رجلا نبيا رسولا خاتما لرسله… و لم يبعث خاتم أنبيائه و رسله من العجم أو الفرس أو الزنوج، و هو القادر على ذلك و القاهر فوق عباده جميعا…؟ فهذا السؤال لا يمكن لأحد أن يجيب عليه، بمن في ذلك العرب أنفسهم ؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته! غير أن ذلك لا يتناقض مع القول إن العرب أودع الله فيهم خصائص متعهم بها دون بقية الشعوب، تمهيدا و تحضيرا و تأهيلا لحمل رسالة الإسلام العظيمة. و لا راد لفضل الله الذي يؤتيه من يشاء . فمنذ أن فتح العرب العراق و حطموا الحضارة الوثنية في فارس ، لم يستثن الشعوبيون جهدا في سبيل القضاء على العرب و الإسلام، معا بالتشنيع على العرب و الدس في الإسلام…
و الغريب في حذلقات أصحاب المنطق الشعوبي ، من كل الأمم، هو ربطهم لفضل الإسلام على الناس بذم العرب و الانتقاص منهم و من دورهم في هذا الدين؛ و كأن ذم العرب و نعتهم بأقبح النعوت و أخس الأوصاف لازمة ضرورية لتبيان عظمة الإسلام و عالميته؛ و كأن نسبة أي فضل أو محمدة للعرب يترتب عليها تقليل من الأهمية الكونية للإسلام!
إنه منطق غريب ، و غرباء أهله، يذكرنا بأولئك الذين لا يتحملون الحديث عن أهمية اللغة العربية ؛ و يسعون بكل جهدهم للحؤول دون ترسيمها لغة الإدارة و العمل في موريتانيا ؛ معتبرين ذلك تعديا على كونية الإسلام و على حقوق غير العرب من المسلمين الزنوج و الفلان في وطنهم- موريتانيا!
و كأن إهمال اللغة العربية و الإبقاء على اللغة الفرنسية ، لغة إدارة و تواصل و عمل للموريتانيين، هو ما يضمن الحقوق الاقتصادية و الثقافية غير منقوصة للأقليات القومية في البلاد ! شيء مدهش في غرابته!
إن الفئة ، التي تذم العرب ل” تعظيم” شأن الإسلام لا ينتبهون ، أو يتعمدون، إلى قلة الأدب ، على الأقل، مع نبي الإسلام ، عليه الصلاة و السلام، الذي ينتمي للعرب. فهذا الرسول صلى الله عليه و سلم عدّد هو نفسه آباءه العرب، بلا فخر!
فالعرب كانوا أمة و شعبا واحدا ؛ و كانوا يتمتعون بوعي قومي ثاقب بانتمائهم القومي المشترك.؛ عكسا لما ذهب إليه الشعوبيون في تخرصاتهم. فالشعوبيون يروجون أن العرب لم يكونوا شيئا مذكورا في التاريخ قبل الإسلام. و كأن هذا الرسول الذي ما زال ربه ينتقيه من أطهر الأرحام و أطيب الأصلاب ، إنما بعثه الله من فراغ قومي و اجتماعي… أو من بين عصابة تجمعت من شذاذ الآفاق !
لم يكن العرب ، أيها الجاهلون، تجمعا من الرعاع ؛ بل كانوا أمة لهم إقتصاد و تجارة و فلسفة وجودية… و أعراف و عادات و ثقافة و فضائل سامية جاء الإسلام ليتممها و ينقحها و ينقيها من الشوائب السيئة التي لا يخلو منها أي مجتمع إنساني. و لم ينشئ الإسلام للعرب خصال فضل جديدة إنشاء، و إنما كمل النقص في فضائلهم و مكارم أخلاقهم و أخضع مرجعية ضوابطها لدين الإسلام بدلا من دينامية تطور مجتمعهم، و أزال عيوبهم و الشطط في سلوكهم.
لقد كانت جغرافية العرب و تضاريسها هي مهبط الوحي السماوي و موطن أولي العزم من رسل الله، مع رسل آخرين، ولذلك لم يكونوا بعيدين عن التشريع و التنظيم و التعمير ؛ و ذلك ما يتجلى في القرآن نفسه و في شعر العرب حين يشبهون بقايا المسلات و المخطوطات القديمة ببقايا الوشم و الأطلال الدارسات… و حين يذكر القرآن قوم عاد و ثمود و ما خلفوا من آثار و مآثر قوة حضارية، ليس أقلها مدينة إرم ذات العماد … و روعة صنعة البناء في جوف الجبال ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون و إذا بطشتم بطشتم جبارين ) … و كما جرت الإشارة إلى حدائق ذات بهجة في اليمن و العراق و الشام…
إن القرآن الكريم، الذي يتلوه المسلمون جميعا بالغدو و الآصال، لم ينعت العرب ، في الجوهر، بصفة قبح أو ذم ؛ و لم يذكر أنهم لم يكونوا شيئا مذكورا ؛ و إنما ذكر أن الرسول جاء ليصحح عقيدتهم و يصقل عاداتهم من الرواسب و الشوائب المنافية لفطرة الإسلام مثل عادة وأد البنات ؛ التي كانت شططا في الخوف من الوقوع في عار السبي عندما يرى العربي نفسه عاجزا عن منع سبي بناته الكثيرات اللاتي لا يستطيع حمايتهن ، فيتخفف من بعضهن، وأدا. فصحح الإسلام هذه العادة السيئة كما صحح لهم مختلف الأنكحة الفاسدة … و الربا الذي أخذوه من ممارسات اليهود في التجارة… و غير ذلك من الممارسات المنافية للفطرة الإنسانية السليمة.و القرآن لم يتحدث عن العرب إلا بصيغة الجماعة … و شرفهم بأن خاتم رسله منهم… و شرفهم بنسبة كلامه إلى لسانهم. فالله يقول في محكم كتابه: 《 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله》و يقول 《 اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا》و يقول 《 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم》و يقول 《 و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا 》… قد يقول قائل إن هذه الخيرية تخص المسلمين جميعا. نقول لا خلاف في ذلك. و لكن هذه النصوص ، و غيرها كثير، حين نزلت لم يكن شعب أو أمة أخرى قد اعتنقت دين الإسلام؛ الأمر الذي يعني أن للعرب أفضلية بالسبق، على الأقل، إلى هذا الفضل و هذه الوسطية و هذه الخيرية. حين إلتقى رسول الله عليه الصلاة و السلام سويدا بن الصامت و عرض عليه الإسلام ، رد عليه: سويد ” ربما الذي معي هو الذي جئتني به” فقال رسول الله (ص) : أعرض ما عندك . فقال سويد :” كتاب فيه حكم لقمان” فأمره رسول الله (ص) بقراءتها. فقرأها سويد. فقال رسول الله (ص) : هذا كلام حسن ؛ لكن الذي معي أفضل منه. ثم قرأ عليه من القرآن. و هذا دليل على أن العرب قبل الإسلام كانوا مهتمبن و معنيين بالفضيلةو الحكم. و هم أكثر الأمم جرت على لسانها الحكم… و الأقوال العابرة للزمن.
و على مستوى الوعي القومي المشترك، كونهم أمة واحدة ،و إن كانت في حالة تمزق كما هو حالهم اليوم، و فصلت بينهم المفازات، فإنه يكفي أن نورد حالة واحدة : هي انتصارهم لأبو مرّة سيف بن ذي يزن حين انتصر على الروم. فقد وفد عليه وفد من أقيال قريش للتهنئة برئاسة عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف و قال خطبته الطويلة ؛ نقتطع منها للجاهلين بالأمر هذا المقطع: ” أيها الملك إن الله أحلك محلا رفيعا ، صعبا منيعا، باذخا شامخا، و أنبتك منبتا طابت أرومته و عزت جرثومته ، و نبل أصله و بسق فرعه في أكرم معدن، و أطيب موطن ؛ فأنت – أبيت اللعن- رأس العرب و ربيعها الذي تخصب، و ملكها لذي له تنقاد ، و عمودها الذي عليه العماد ، و معقلها الذي تلجأ إليه العباد، سلفك خير سلف ، و أنت لنا بعهدهم خير خلف ، و لن يخمل من أنت سلفه. نحن أيها الملك حرم الله و ذمته و سدنة بيته….” و سيف بن ذي يزن، هذا، هو الذي تصدى للأحباش لطردهم من أرض العرب و له قصص مشهورة تجمع بين فضائل النخوة العربية و الإباء و الشجاعة و المروءة و عزة النفس … فقد تقدم إلى قيصر ، ملك الروم، يستنصره على طرد الأحباش ؛ فرفض قيصر بحجة التحالف مع الأحباش. فانطلق سيف بن ذي يزن إلى كسرى و قال له : ” أيها الملك غلبتنا على بلادنا الأغربة ” فرد عليه كسرى : ” لم أكن لأورط جيشا من فارس بأرض العرب ؛ لا حاجة لي بذلك” لكن كسرى وصل سيفا بن ذي يزن بمبلغ ضخم من المال . فقام سيف يوزع المال على الناس ، قائلا قولته المشهورة:” و ما أصنع بالمال؟ ما جبال أرضي التي جئت منها إلا ذهبا و فضة! و بعد كل هذا الخذلان من الروم و من الفرس لسيف بن ذي يزن ، فقد انتصر العرب على الأحباش؛ حيث مدح أمية بن الصلت سيفا بن ذي يزن مفتخرا بنصره القومي. و عندما قام الفرس باحتلال أرض العرب في العراق رفع سيف بن ذي يزن أيضا راية الكفاح المسلح ؛و قام بالتعبئة القومية في صفوف القبائل العربية لطرد المعتدين من أرض العرب..
ذلك نزر قليل من المثاليات الراقية للعرب؛ و ذلك بعض التوهج القومي العربي قبل الإسلام. فجاء الإسلام، منة و نعمة عظيمتان من الله، لينظم صفوف العرب في حياة كريمة طاهرة و ليعزهم بعد ذلة بسبب التفرقة و الشقاق؛ تماما كما هو واقعهم اليوم. فالحديث عن عظمة الإسلام و عن أثره العميم على العرب ليس موضوع جدال؛ لكن لا دليل على أنه لا يمكن الكلام عن عظمة الإسلام و عالميته إلا مشروطة بذم العرب ؛ كما تعودت عليه أقلام الشعوبية القديمة و الحديثة. فالشعوبية، منذ البويهيين الفرس و السلاجقة الأتراك، تسعى لإقامة تعارض مصطنع بين العروبة و الإسلام. و أما التدليل على عدمية العرب بأنهم كانوا ، قبل الإسلام، قبائل متناحرة، فهذا استدلال سقيم. فالقبائل الموريتانية كانت في تقاتل مستمر في صحراء جرداء؛ و لم يكن ذلك مانعا لهذه القبائل دون تفجير حياة علمية و أدبية في ظروف يستحيل فيها على غيرهم البقاء على قيد الحياة. و من فضل الله على العرب أن ضرب أمثلة الوعد و الوعيد يوم القيامة من بيئتهم. فالجنة طيبة باردة كحدائق اليمن.. و النار حامية كأنفاس السموم المارة بصخور مكة! كما أنزل آيات قرآنية في شأن رجال بأسمائهم من العرب، مدحا .. أو ذما ! فمن ذا الأعجمي الذي كان سببا في نزول قرآن، يتلى إلى اليوم، إشادة أو تقريعا! و لو أن فضل القرآن على العرب اقتصرا على توحيدهم ،من بعد تفرق و تمزق، لكان في ذلك أعظم مبدأ قومي!
فالحمد لله أن الله تعهد بحفظ القرآن ، و لو لم يحكم بهذا الحفظ لكان الشعوبيون حرفوه تحريفا ما بلغه بنو اسرائيل في التوراة… و لكان الشعوبيون الجدد ( حلفاء أمريكا و بريطانيا و حلف شمال الأطلسي) نزعوا من القرآن كل ذكر للعرب ، تصريحا أو تأويلا، و لغيروا مضارب الأمثال و أسباب النزول … و كلما يمت لنزول هذا القرآن على رجل من العرب، حسدا من عند أنفسهم!
بقلم/ محمد الكوري ولد العربي.