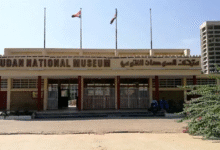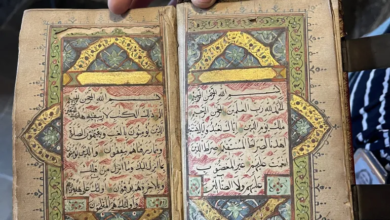النقاش حول الكوارث الطبيعية: تصادم الفلسفة وعلوم الدين


الفيلسوف العثماني (التركي الكردي) بديع الزمان النورسي (1878-1960) والفيلسوف الفرنسي فولتير (1694-1778) يفصل بينهما أكثر من قرنين من الزمان وأكثر من 4 آلاف كيلومتر من الجغرافيا، إلا أن الفكر البشري لا يعرف هذه المسافات والفروق، خاصة عندما يتعامل مع أحداث متشابهة مثل الزلازل التي تجتاح العالم في الوقت الحاضر، بعد حوادث طبيعية مدمرة مثل زلزال تركيا وسوريا والمغرب، وفيضانات ليبيا.
ففيما قال فولتير مرةً: “لا أعرف ما هو أنفع لإكمال الذوق من المقابلة بين أكابر العباقرة الذين تناولوا عين الموضوعات”، يثير اهتمامنا ما قاله النورسي عن زلزال 1939 الذي ضرب مدينة أرزنجان التركية وأسفر عن وفاة نحو 40 ألف شخص وتدمير آلاف المنازل. وماذا قال فولتير عن زلزال لشبونة في 1755، الذي قتل فيه عشرات الآلاف وأدى إلى تشقق الأرض وانهيار المباني؟
هذا هو موضوع كتاب جديد صدر مؤخرًا عن دار المحرِّر بالقاهرة، من تأليف الأكاديمي المصري نبيل فولي، الأستاذ بجامعة السلطان محمد الفاتح بإسطنبول، تحت عنوان “علم الكلام.. قضايا وشخصيات”. يتناول الكتاب موضوعات تقليديّة في مجال الدراسات الكلامية ولكن بأسلوب حديث وتحليلي. يسلط الضوء على الخلفيات والدوافع والأهداف التي تؤثر في تطور الأفكار واتجاهاتها. تعتبر هذه الكتابة تطبيقًا عمليًا لعلم تاريخ الأفكار الذي بدأ الحديث عنه منذ عقود، حيث يبحث في تأثير الزلازل والكوارث الطبيعية على الفكر البشري وتطوره.
فلسفة الزلازل
في الفصل المعنون به “علم الكلام.. قضايا وشخصيات” في الكتاب، قدم المؤلف نموذجًا مقارنًا لمواقف المفكرين من أحداث الكوارث الطبيعية، بهدف إبراز التأثيرات النفسية والثقافية والظروف الحضارية العامة التي تشكل هذه المواقف. اختار المؤلف شخصيتين من خلفيتين ثقافيتين مختلفتين لدراسة موقفهما الفكري من الزلازل، حيث يثري الحوار حول هذه الصدمة المؤلمة التي تصيب الناس من وقت لآخر.
ففي سياق هذا الفصل، انتقد فولتير الذين أرادوا تفسير زلزال لشبونة عام 1755 على أنه عقوبة إلهية للناس على آثامهم. وصاغ ذلك في شعر قائلاً:
“هل ستقول: إن الله انتقم منهم، وإن موتهم هو ثمن على جرائمهم؟!
أيُّ جُرم وذنب اقترفه الطفل الذي يرقد على ثدي أمه يسيل منه الدم؟!
وهل انغمست لشبونة في الفسق أكثر من لندن أو باريس اللتين تعيشان في سعادة؟!
الحقيقة أن لشبونة محطمة، والناس يرقصون في باريس”!
وقد رفض أيضًا قول من اعتبر أن هذه الكوارث جزء من نظام الكون الكامل الذي لا يمكن أن يكون هناك أفضل منه. وقال:
“تقولون: كل شيء على ما يرام، وكل شيء ضروري!
هل تعتقدون أن هذا الكون سيكون أفضل بدون هذه الهاوية التي ابتلعت لشبونة؟!”.
وأيضًا أثرى فولتير هذا النقاش من خلال كتابة قصيدة طويلة ورواية تحمل اسم “كنديد”، حيث قام بالرد على أصحاب مذهب التفاؤل وفلسفة الألم. قدم فولتير رؤيته بأننا يجب أن نقبل العالم كما خلقه الله بجميع هداياه وكوارثه، وأن يجب علينا التعاون للحد من التأثيرات السلبية لهذه الكوارث. هذا المذهب أصبح لاحقًا طائفة عملية، واكتسب نفوذًا كبيرًا، وتطور ليصبح مذهبًا إلحاديًا شبه صريح في رواية “الطاعون” للكاتب الفرنسي ألبير كامو.
الخير والشر عند فولتير والنورسي
من الملاحظ أن فولتير اختار لسرد الموقف الصوفي من الكوارث شخصية صوفية مفكرة عثمانية. ففي روايته “كنديد”، اجتمع الأبطال الذين تعرضوا لسلسلة من النكبات والكوارث مع درويش صوفي مشهور يعيش في تركيا. قاموا بمشاركته مختلف الأفكار والأسئلة حول الكون والإنسان.
بالنسبة للنورسي، فقد قام بمواجهة الملحدين الذين حاولوا تفسير زلزال أرزنجان عام 1939 بأنه نتيجة عشوائية طبيعية وليس له علاقة بقرار إلهي. نفى النورسي وجود علاقة طردية بين الكوارث وأفعال البشر، وأكد أن المصائب ليست علامة على سخط إلهي مطلق. بدلاً من ذلك، رأى أن هذه الكوارث تقدم فرصة للمؤمنين للتعبير عن تواصلهم مع الله من خلال الصدقة والعمل الخيري، وتكون فرصة لتكفير الذنوب وزيادة القربان.
بالمجمل، يمكن القول إن فولتير والنورسي اختلفوا في مفهومهم للكوارث الطبيعية وتأثيرها على الإنسان والعالم. ففولتير اتجه نحو التشكيك في الأمور الدينية والإلهية في وجه الكوارث، بينما اعتمد النورسي على الإيمان والتفسير الروحي لهذه الأحداث كوسيلة لتعزيز الإيمان والتواصل مع الله.
أكد النورسي أن الأسباب المادية والطبيعية للكوارث يجب أن لا تحجب عنا النظر في الوجود الإلهي والقدرة الإلهية التي تقف وراء هذا النظام الكوني. وأشار إلى أن البشر غير قادرين على خلق حتى شجرة واحدة من الشجر المليارات التي تغطي الأرض، وبالتالي ينبغي علينا أن نعزو هذا التنظيم والتنسيق الرائع في الكون إلى الخالق المبدع والحكيم.
أيضًا، أكد النورسي أن الزلازل والكوارث الكونية تكون وقائع توعية للأشخاص، سواء كانوا مؤمنين أو عصاة. بالنسبة لأهل الإيمان، تعمل هذه الكوارث كإيقاظ لهم من سباتهم الروحي وتشجيعهم على الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله. ويرى أن وقوع هذه الكوارث في أوقات وظروف معينة يشير إلى أنها تستهدف أهل الإيمان بشكل خاص لتوجيههم نحو الخير والتوبة.
أما بالنسبة لغير المؤمنين، فإن هذه الكوارث تعمل على نفس الغرض من خلال تنبيههم وتذكيرهم بأن هناك قوى كونية تفوق سيطرتهم وتحكم الكون. تمثل هذه الكوارث نوعًا من التجديد في الكون وفرصة للناس للتفكير في الأمور الروحية والكونية بشكل أعمق.
باختصار، يرى النورسي أن الكوارث الكونية لها هدف روحي وتوعوي في توجيه البشر نحو الإيمان والتوبة، وأنها تشكل جزءًا من التنظيم الكوني والتجدد الذي يحدث في الكون.
الوظيفة الفكرية والاجتماعية للكلام
في فصل آخر من الكتاب، تم استعراض الوظيفة الفكرية والاجتماعية للتعليقات العقدية التي وردت في كتاب “جامع السنن الكبير” للإمام الترمذي. يُعتبر هذا الكتاب مشهورًا بسبب سنن الترمذي والتي تحتوي على أحكام دينية وأخلاقيات. وتُظهر هذه التعليقات التواصل المباشر والقوي بين الكتب الدينية والثقافة والتصرفات الحياتية. بالإضافة إلى تقديم الأحكام الشرعية في مجالات الفقه والأخلاق، تم توجيه اهتمام خاص إلى التعليقات التي أُضيفت إلى بعض هذه الروايات لتوضيح موقف السلف من مسائل محددة.
الكتاب يرصد معركة فكرية تاريخية في القرن الثامن الهجري، وهي مرتبطة بالخلاف القائم بين مدرستي الأشعرية والسلفية. هذا الخلاف يظهر حاليًا بشكل مشابه في المجتمع الحديث، حيث ينشأ نقاش حاد بين الطرفين حول القضايا الدينية والفقهية. تظهر هذه الدراسة أن هذا النزاع ليس جديدًا، بل كان موجودًا منذ فترة طويلة، وأنه يمكن استخدام التاريخ لفهم أصوله وتطوره.
الكتاب يتكون من ستة فصول تتعامل مع مختلف الشخصيات والأفكار التي تمثل فترات زمنية ومكانية متنوعة. يتناول الكتاب شخصيات مثل أحمد بن حنبل والكرابيسي والبخاري والترمذي وابن فورك والجويني والذهبي والسبكي وفولتير ومحمد إقبال والنورسي وحسن الشافعي، ويقدم تحليلات مفصلة لأفكارهم ومواقفهم. يبرز الكتاب أهمية دراسة هذه الشخصيات والأفكار في فهم النقاشات الدينية والفكرية الحالية.